حكايا الهَجر الصغيرة | قصص قصيرة

المحجرة
لعق وجهي مثل كلب، لكنّه بخلاف الكلاب لم يكن سعيدًا بل مستفَزًّا وجريحًا، تساقط لعابه بقايا فول سودانيّ زحفت بصعوبة من بين أسنانه المزروعة حديثًا وأكملت موتها على خدّي. تسرِّب الستائر حزمة من أشعّة شمس كانونيّة هرمة تشبه تلك الّتي وقفَت معي فوق قبر أمي. لكنّني لا أشعر بالموت الآن بل بالملل، وبانسداد خانق في الجيوب الأنفيّة. لذا كان عليّ أن أدير وجهي إلى الجانب الأيسر، وأنتظر.
يُقال كثيرًا إنّ ثاني أبشع شيء في هذه الحياة بعد الحياة نفسها هو الانتظار، المرتبة الأولى في قائمة البشاعة محجوزة دائمًا لشيء طارئ، أمّا الانتظار فهو ثابتٌ من الثوابت، يولَد معك ويعتاد التأجيل.
يلتصق خدّي في الأرضيّة الباردة ويلسعني الفراغ الّذي تركه ضرس العقل قبل سنة، لكنّني أختار تتبَّع القشور المتساقطة من السقف على جيش الأحذية المتشظّي. أحذية حزينة، تنتمي إلى عوالمَ صناعيّة، أحذية كثيرة لشخصين، لثلاثة، لأربعة. أنا وحيدة داخل «محجرة» الفول السودانيّ. أتخيّل وجهي كحقل رُشّ ببذور الحجارة للتوّ، تبرز منه قطع صغيرة صلبة تجرح مرّتين: باللمس والرؤية. سأعلّق على صدري لافتة: "احذر، فتاةٌ تُربّي الحصى على وجنتيها". يصفعني، كي أقتنع بأنّ القرف مصطلح ممنوع بين أفراد العائلة الواحدة، وأنّ أشياء مثل الملعقة المستخدَمة، مشط الشعر، فرشاة الأسنان وحتّى اللّعاب.. مثلها مثل اللّغة: قابلة للتداول.
ما لا يعرفه هو أنّ العائلة بطولها وعرضها قابلة لا للتداول فحسب بل وللمقايضة، وهذه وجهة نظر سبق وطبّقتها غير مرة على امتداد حياتي. المقايضة فعل يتحرّك من الداخل، بمرور الوقت يسبقك إلى الأماكن والأشخاص فيصبح من الصّعب عليك أن تحزر لماذا تذكِّرك السفينة ببطن أمّك ولماذا أضواء المستعمرة تشبه مشهدَ بدايات الفجر في بيتكم القديم المستأجَر.
عائلتي، كلّها، مجرّد صورة معلّقة على جدار غرفة الضيوف، والّتي هي بالمناسبة ليست أكثر من صالة صرفَت أمّي عليها جلّ ميزانيّتها لأجل ضيوف لا يحضرون إلّا في اليوم الأوّل من العيد، مرّة كلّ عام لمدّة عشر دقائق، يدمّرونها بأحذيتهم ثمّ يرحلون. لماذا عليّ أن أُجرَح الآن فقط لأنّ فردًا واحدًا منها قرّر أن يدير وجهه داخل الصورة ليعلّمني درسًا في أصول التغاضي عن القرف؟
أُقايض الموقف كلّه بلحظة تأمّل مستعجَلة لطفلة في الثانية من عمرها هرعت إليّ فسبقها ظلّ مشروخ اغْتَصَبَ طفولتها متطاولًا على المفاهيم الصحيحة للأبعاد المنطقيّة الّتي قد تكون مناسِبة لفتاة في مثل عمرها. أنا أيضًا فتاة وأشخاص كثر، وأشياء كثيرة تقاسمني العمر نفسه لكنّها على الدوام أقلّ منّي خذلانًا وألمًا. إذ يبدو لي أنّها داخل مسارات كتلك الّتي تدور فيها كواكب السماء، مقدار حزنها محفوظ، نسبيّ، مثله مثل الانتظار، ثابت ومُحتمَل.
تجلس الطفلة على بطني، لماذا كلّ هذه الملامح الخشنة؟ أنظر إلى أظافري، أنتزع جلدًا ميّتًا من طرف إبهامي بأسناني، تقلِّدني، تنتظر حدوث شيء ما. لكنّني لا أنهض، لا أحزن، لا أبكي ولا ألعب معها، لقد أنجبتُها ومع ذلك أشعر على الدوام بأنّني أربّيها من بعيد، كأنّها ابنة صديقتي، أمسّد أحيانًا على شعرها، أربِّت على كتفها ثمّ أنساها بعد دقيقتين. أنساها طوال اليوم وأوبّخها فقط حين تخطئ أو تفعل أيّ شيء يدلّ على وجودها الناقص والمشوّه.
تبكي، أريدها أن تغرب عن وجهي لتستعمر زاوية أخرى، دمية أخرى، أمًّا أخرى. أنظر إليها بكسل، لا أطيق هذا الشبه المُحرج بيني وبينها، أخيرًا قرّرت فعل شيء ما.
ألقيتها من النافذة.
شيء واحد لا أنساه من بقايا أمي: صورة ذهنيّة مهترئة لامرأة نحيلةٍ حافية تجيد البكاء خلف مغسلة المطبخ، مكانها الاستراتيجيّ الّذي تخاطب من خلاله العالم، عالمها الضيّق، نحن. لو كانت هنا الآن لوبّختني من مكانها ذاك، أعرف كيف تبدأ فقرة التوبيخ بصراخ يتحوّل تدريجيًّا إلى بكاء، ثمّ تمتمة تكرّر نفسها بغرائبيّة مضحكة كلّما اصطدمت نظراتنا بأيّ مكان داخل البيت.
ألقيتها يا أمّي من النافذة ثلاث مرّات، لم تمت، كلّما ألقيتها ورجعت إلى استلقائي البارد حيث كنت عادت إليّ وجلست على بطني. لا توبّخيني، الإطلالة هنا جميلة، النافذة تسرِّب مفهومًا مريحًا لمعنى الحياة داخل طبيعة في أوج اخضرارها، لكنّ الهواء البارد جفّف الحصى على وجهي، أنا صفراء تمامًا، وثمّة فجوة مُحرجة بين ما أراه وبين ما يراني. لم أعد ابنتكِ الجميلة بعد الآن، لم أكن قطّ بنتًا جميلة بالمعنى الفضفاض والخالي من ضمائر الملكيّة، هجرني الجمال كما هجرتني المشاعر الّتي تحضر للمرء على السليقة، أحتاج دائمًا إلى منبّهات غير حسّيّة لأخلق إحساسًا ما، يكون في أفضل حالاته وليد الاصطناع.
يزورونني في محجري، يتضاحكون حولي، يرمون لي قطعًا من الشوكولاتة الرخيصة، أخبّئ وجهي بين يديّ، يقتربون منّي، يمسِّدون على شَعري الدّبق، ثمّ يملّون ويعودون إلى حياتهم وكأنّهم يقولون لي: "لا بأس، هذه أعراض الساعات الأولى، ستعتادين على وجهكِ الجديد بمرور الوقت".
اليوم، عاركتني لفظيًّا سيّدة عجوز، جدّتي، أشتُمها منسحبة من المكان، يضربونني، لا شيء يؤلمني، ما لا يعرفونه هو أنّ تلك الطفلة ذات العامين بكلّ ما في روحها من طفولة مغتَصبة جابهت أعتى أنواع الموت وعاشت، لأنّه ما من أحد يتأذّى وعلى وجهه هذا الكمّ من الحصى.
***
حكايا الهَجر الصغيرة
تنظرُ إليّ باختناق، تشبيه كسيح يحاول وصف سماء زرقاء ’ترمّدت‘ أو لنقل تحوّلت إلى اللون الرماديّ من فرط استنشاقها للغاز المسيّل للدموع. كنت ألعب وحدي في المقبرة حين تلوّنتُ بألوان السماء وانهمرت دموعي. لم أخف، فالحياة بالمجمل درجات متحوِّرة على نحو لا نهائيّ من اللّون الرماديّ، كما أنّ الأرض هي مرتع القبور لا السماء. شجّعت نفسي بهذه الأفكار وحاولت الاختباء خلف شجرة صنوبر تطلّ على بيتنا، بدا لي هُلاميًّا ومشوّهًا على نحو محرج بالنسبة لفتاة مضيافة مثلي، ماذا سأقول لصديقاتي في يوم ميلادي التاسع؟ "تفضّلن، هذا بيتي، لكنّه دبقٌ قليلًا، لا تنزعن الأحذية واصعدن مباشرة إلى غرفتي".
يمرّ جيب الجيش من الطريق الترابيّ وألمح أضواءه البرتقاليّة، لا بدّ أنّهم رأوني، سيأخذونني الآن. يستجوبونني عن سبب وقوفي تحت شجرة صنوبر داخل حدود المقبرة القديمة. لا موتى جدد منذ ثلاث سنوات. ما الّذي أفعله هنا إذًا؟
- أتشمّس.
قلت بصوت منخفض والدموع لا تزال تغطّيني، كلّي. ومن يبكي هكذا من مسيل دموع "اختفى مفعوله"؟ أنت فتاة غبيّة، الناس لا يتشمّسون في تشرين الثاني، وإن فعلوا فهم لا يجلسون هنا أو تحت أنظار الجيش. أوبّخني. وأقترح على نفسي إجابة أكثر إقناعًا:
- أزور قبر جدّتي.
سأفقأ عينك أيّتها البنت المتهوّرة، فقط حين تستعيدينها. جدّتك لأبيك معمّرة أكثر من أشجار «العرقد» وجدّتك لأمك أجنبيّة ماتت في تلك البلاد الغريبة. سيأخذك الجنديّ من يدك ويسألكِ عن مكان القبر، سينهض ميّت عصبيّ ويخبره بأنِّكِ كاذبة، ولكن لا ينبغي عليه أن يأخذك لهذا السبب فالأطفال جميعهم كاذبون، وإنّما لأنّكِ مزعجة، ولم يصرف أحد أيّ وقت على هندمة أخلاقك أو حبالك الصوتيّة.
الوقت يمضي والجيب يتوقّف مكانه، يلوّح لكِ الضوء البرتقاليّ فتتكئين بظهركِ على جذع الشجرة ثمّ تجلسين فتسري برودة شبحيّة على طول ظهرك المتعرّق البارد، أنتِ والأشباح سواء. تُخرسينني بنظرة مركّزة أكثر على بيتنا وتهمسين:
- سأكون بنتًا مطيعة، الآن، في اللحظة الّتي ينتهي فيها كلّ هذا.
أسخر منكِ فتقضمين إبهامكِ ليوقفني الألم. وأتوقّف.
أفكاري يرثى لها. لن أسمح لأحد بالتفكير نيابة عني. سأنهض وأسير بهدوء نحو البيت، سأدّعي أنّني أرى جيّدًا، ولن يسألني الجنديّ عن أيّ شيء، وإن سألني سأقول له إنّني صغيرة على الأسئلة، ولا أعرف ما هو السؤال.
أجلس القرفصاء استعدادًا لتنفيذ الخطّة، وأطلق قدماي للريح، وللقبور أيضًا، وللقليل من الأعشاب الّتي اكتسبت خضرة طازجة لوّثتُها الآن بالتراب العالق في حذائي. شعرت بأنّني أقفز من الشتاء نحو الربيع، والمقبرة متروكة خلفي، سأهجرها إلى الأبد، ستكون علاقتي الوحيدة بها هي المرور اليوميّ نحو المدرسة، وحين أموت لن أحصل على قبر ينظر إلى سماء بألوان كسيحة، ولن يرمقني حذاءٌ معلّق على أسلاك الكهرباء نسيه ابن جيراننا هناك عن قصد، ولن أرى بجانبه طائرة ورقيّة ممزّقة خسرت ألوانها لمبيتها سنوات طويلة تحت الشمس، الأمطار، الثلوج، غبار السيّارات والناس. خلفي يرقد موتى من كافة الأعمار، بعضهم يحدّق في هذه الطائرة المتعطّشة إلى أيّ حضور لونيّ غير البياض المليء بأسماء مقشّرة وتواريخ عفا عليها الزمن.
حين أموت لن أُدْفَنَ حول هذا التشوّه البصريّ كلّه ولن أكون سببًا في حدوثه.
كانت أفكاري لاهثة مثل أنفاسي، ممزّقة بين الجيب العسكريّ أمامي والمقبرة خلفي. لم يلحظني أحد، لا الجيب العكسريّ ولا طائر الحسّون الّذي فرّ من قفصه، ولا معلّمة التاريخ الّتي كانت تتلصّص من نافذة بيتها لتلفّق لنا حكاية فور عودتنا إلى مقاعد الدراسة. فقط حين مررت من جانب بيتها تذكرت أنّها معلّمة التاريخ الوحيدة الّتي حصلت عليها في حياتي، ولم تتغيّر منذ الصف الأوّل حتّى اليوم. لديها سحنة كئيبة قاتمة تطليها بألوان أشدّ قتامة، وتترك فسحة مغامرة للون أحمر مقيت يغطّي الشفتين ويجرح بخطّ رفيع متعرِّج وجنتيها. إنّها تدريب بشريّ غير احترافيّ على القلق الّذي سنعانيه فور بلوغنا. نسيت أنّها جارتنا، فالعبث مع الموتى ينسيك الأحياء، لا أجتازها قبل أن أدعو من كلّ قلبي إصابتها برصاصة تفقأ عينها وتصير ’عوراء‘ إلى الأبد، مثلها مثل الأراضي الّتي اعتادت الكذب علينا بها: صحراء، جرداء، لا ماء فيها. نقلًا عن الخريطة.
أُمسك بقلبي وأقف أمام بيتنا، تستقبلني رائحة أعرفها ولكنّني نسيت اسمها، أو لعلّي لم أعتد على تسميتها بأيّ اسم معروف، تُخيفني رغم انتمائي الشديد لها، أحاول تجاهل شعوري الّذي قد يكون نتيجة الوصول أخيرًا بعد كلّ ما حدث. أنفض ثيابي بيدي وأعقد شعري ثمّ أفتح الباب بانتشاء سرعان ما يصطدم بثلاثة رؤوس انتقلت حركتها من التلفاز إليّ، ويتلاشى تمامًا تحت وقع الكلمات الّتي قالها بابا:
- ألم أطردكِ من البيت؟
نهضت زوجته وأخرجتني من شعري "الّذي سرّحته لأجلهم"، وقالت مؤكِّدة:
- مرّت ثلاث سنوات وما زلتِ عاجزة عن إيجاد حفرة حقيرة لكِ بجانب أمّكِ في المقبرة.
تقدّم نحوي جنديّ يحاول الموزانة بين خطواته السريعة وسلاحه الثقيل، أمرني بعربيّة مكسّرة:
- ارجع لبيت يا ولد.
كنتُ أمام بيتي الّذي لفظَني، ولم أعد أدري إلى أين سأذهب، يكرّر الجنديّ جملته وهو واقف أمامي ثمّ يتأمّلني قليلًا، يصوّب سلاحه على صدري ويقتلني بأعصاب تالفة.
وحدي أصارع الموت في الفناء، تخيّلتها تنظر إليّ باختناق، تصريح رفيع لا يليق بمعلّمة تاريخ عوراء نزحت عن المشهد تاركة خلفها طفلة عالقة، بسببها صرت كلّما مرّ زائر جديد من أمامي في المقبرة القديمة، أنهض على حسّه ممسكة قلبي، والرياح تضرب الحذاء المنسيّ على الأسلاك السوداء فوق رأسي مصدرة قرعًا خفيفًا يسمّيه شبح جارتي العجوز: حكايا الهجر الصغيرة.
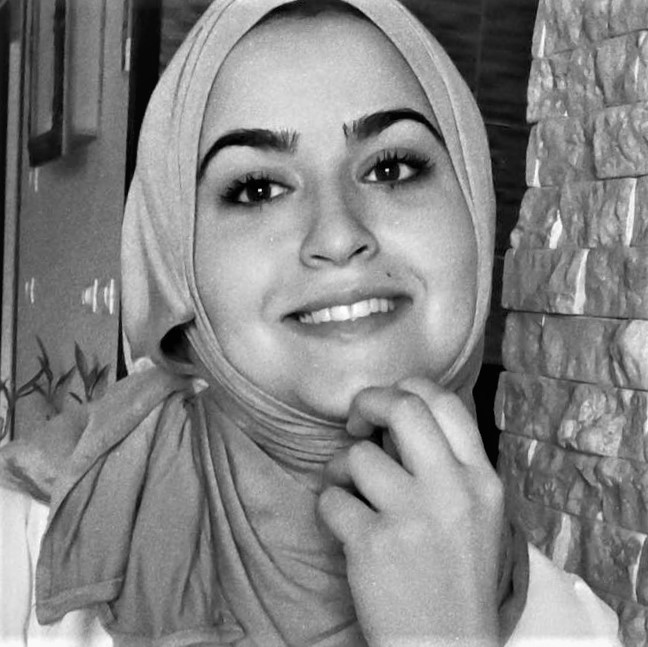
كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، دَرَسَتْ «الإعلام» في «جامعة بير زيت»، وصدرت لها عدّة روايات، وتكتب في عدد من المنابر الإعلاميّة الفلسطينيّة والعربيّة.







